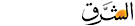تغريد دارغوث إذ ترسم ضد تسليع الكارثة
بقلم نديم قطيش
وظف الرسامة اللبنانية تغريد دارغوث فكرة البطاقات البريدية، التي تحتفي بجماليات الطبيعة والمواقع الأثرية الشهيرة والملامح المندثرة من حيز لبنان المديني، مدخلاً لاستكشاف تصورات اللبنانيين عن ذاتهم الجمعية.
لا يُختلف على الدور الذي تلعبه النوستالجيا في حياة العديد من اللبنانيين، وسيلةً للدفاع عن الذات المهددة. هذا ما تلاحظه دارغوث في هوسهم بماضيهم، في ظل التآكل المستمر للهوية اللبنانية الجامعة. تنبهنا إلى أن الحنين لصور ورموز بعينها هو حالة إنكار جماعية للواقع. مسكنات سيكولوجية أكثر منها عناصر تجسد إرثاً مشتركاً.
لذلك لا تكتفي دارغوث في لوحاتها بنقد تسليع النوستالجيا، من خلال تقديم الأرزة والصخرة والبحر والمعبد وجبران خليل جبران، كـ«كيتش» غارق في الجمالية السطحية والمبالغات العاطفية الخالية من أي قيمة فنية حقيقية. بل تفرض علينا في معرضها الأخير، في صالة صالح بركات في بيروت، امتحان الموازنة بين هذا الإرث الثقافي، والحاجة إلى تجاوزه. من هنا إصرارها أن ترفع صور الكارثة النازلة باللبنانيين وتعلقها جنباً إلى جنب مع صور لبنان المتخيل أو الآفل. لوحات قاسية عن صوامع القمح المترنحة بعد انفجار بيروت عام 2020، أو الطائرات المحطمة والسفن الجانحة، التي تحمل جميعها كنايات عن ترنح وتحطم وغرق البلد برمته.
تصرخ لوحات دارغوث في وجوهنا أن الملمح الأكثر ألفة للبنان في لحظتنا المعاصرة هو ملمح الكارثة الأسطورية التي حلت به، على مراحل عدة، لا رومانسية الماضي المندثر ورموزه البسيطة، التي يراد لها أن تخفي المآسي العميقة في التاريخ الحديث للبلد.
من خلال التجاور المتوتر بين لبنان الكارثة ولبنان النوستالجيا، تدعونا لوحاتها للاعتراف بما آلت إليه الهوية اللبنانية من «فيتشية» (Fetishism) صارخة، أي التعلق الهوسي، بفتات الهوية، وجعل الفتات يقوم مقام الهوية كلها، أكان هذا الفتات صخرةً أو شجرةً أو بحراً.
تجعل دارغوث من أرزاتها صوراً معزولة ومكررة، في مسعى لتجريدها من عظمتها الرومانسية وكشف هشاشتها. تظهر الأشجار في لوحاتها وكأنها متجمدة في الزمن، ومجردة من عمقها الثقافي الأصلي. ترسم لتفضح التسليع النوستالجي، والذاكرة الانتقائية، التي تكتفي بسردية اختزالية للهوية الوطنية تعج بالرموز والتبسيط الاستهلاكي والإفراط الاستعراضي، في ظل الانهيار الحاصل واضطراب معنى أن تكون لبنانياً اليوم.
تشاء الصدف أن يتزامن معرض تغريد دارغوث مع الإعلان عن توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فسلامة ظل لفترة طويلة خلت يمثل إحدى بطاقات لبنان البريدية الحية التي تحتفي «بعبقرية» الرأسمالية المصرفية، المنتهية إلى أكبر عملية سطو على مدخرات المودعين. كما الحال في تصوير دارغوث للهوية الوطنية المجوفة، ينطوي اعتقال سلامة أيضاً على تجويف موازٍ لفكرة المحاسبة والعدالة. يصعب الاقتناع بأن توقيفه يمثل تحولاً حقيقياً نحو العدالة، بقدر ما يمكن وصفه بتسليع الإصلاح لإنتاج عدالة استعراضية تبقي الخلل الأساسي من دون مساس.
في مواجهة هذا الاكتفاء بالرمزيات والكنايات والاستعراض، تقتحم لوحات دارغوث الذاكرة اللبنانية المعقمة والمختزلة، كما تصورها البطاقات البريدية. من خلال لوحاتها تعيد الاعتبار للمأساة على نحو يسمح لها بتقديم النوستالجيا اللبنانية خلفيةً للصراعات والأوجاع التي تشكل جزءاً أساسياً من تاريخ لبنان، لا كحاجب لها.
ينطوي معرض تغريد دارغوث على رعب فسيح، من احتمال «تسليع الألم» نفسه وتحويل معاناة اللبنانيين، كما تاريخهم، إلى سلعة ثقافية عاطفية قابلة للاستهلاك. تستبق لوحاتها صيرورات معقدة لتنبهنا إلى احتمال أن يتحول الألم إلى «بطاقة بريدية» مرئية تُفصل عن سياقها الأصلي.
يندرج النقد الذي تقدمه تغريد دارغوث للبنان النوستالجي ضمن إرث طويل لليسار اللبناني عمل على تفكيك السرديات الريفية التي روجت للنقاء وبساطة العيش. لكن الفنانة اللبنانية تحاذر أن تقترح سردية بديلة، لطالما استسهلها اليسار، عبر دعوات لتبني الدولة المدنية أو نقد الإمبريالية والطائفية السياسية. على العكس من ذلك تأتي خلاصات دارغوث أقل يقينية وأكثر غموضاً.
صحيح أنها نظرت دوماً إلى السياسة من خلال عدسة يسارية عالمية، وتناولت في أعمالها السابقة مواضيع مثل الإمبريالية الأميركية، والتدمير النووي الوشيك، واستخدام الجماجم رموزاً قاسيةً لعواقب السياسات الأميركية. كما تناولت معاناة فلسطين من خلال توظيف شجرة الزيتون رمزاً لمقاومة الكولونيالية الإسرائيلية، ما جعل النضال الفلسطيني جزءاً لا يتجزأ من فنها. وحتى حين أعملت ريشتها في نقد شيوع عمليات التجميل، جعلت ذلك جزءاً من مقاومتها لإمبريالية رأسمالية تحاول فرض معايير صارمة للجمال والجسد تنطوي على منطق استهلاكي واستعراضي لاغٍ للخصوصيات والفرادة.
بيد أنها في معرضها الأخير، تغوص دارغوث أكثر في أسئلة هويتها الوطنية، مثلها مثل مواطنيها بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020 الذي دمر أجزاء كبيرة من مدينتهم وزعزع الكثير من مرتكزات استقرار هويتهم. وأحسب أن هذا التحول من توظيف منظور عالمي واسع في أعمالها إلى التأمل في شأن وطني وشديد الشخصية يمثل لحظة فارقة في مسيرتها. فهو لا يعكس فقط تطوراً في نهجها الفني، بل أيضاً تعمقاً في تعاملها الفكري مع مسألة الهوية وكيفية تركيبها وتفكيكها وإعادة بنائها.
ولعلها عبر شمول تمثال المغترب اللبناني في لائحة الرموز التي اشتغلت عليها، وإنجاز رسوماتها عنه على أقمشة أكياس الرمل المكنية عن الحرب وأزمنتها، تفتح دارغوث باب التساؤل حول مصير الهوية اللبنانية المتشظية. كأنها تحثنا على تأطير رواية الاغتراب اللبناني في إطارها الحقيقي، أي، لا في كونها مادة للاحتفاء، بل في كونها في العمق، إعلاناً عنه انضمام اللبنانيين إلى موجات النازحين الذين تقذفهم المجتمعات المنهارة، والذين إذ يرحلون يحملون معهم صورة أوطان رحلت قبلهم ولن يعودوا إليها.
يجدر الاعتراف ختاماً بأن من أوجه القصور المتأصلة في النقد الفني هو محدودية التأويل ذاته. فالفن غالباً ما يتجاوز الكتابة النقدية التي بحكم طبيعتها تخاطر بتبسيط تعقيداته، وحجب تعددية المعاني الكامنة فيه. وبهذا المعنى، ينطوي التأويل، رغم ضرورته للحوار، على تناقض فاضح، إذا غالباً ما ينتهي إلى الحد من الأفق الذي يطمح إلى توسعته، وهو ما يقتضي الاعتذار من تغريد وصالح ومغامرتهما الجديدة.
نديم قطيش