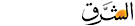لحظة فلسطينيّة لا تتكرّر.. من يستثمرها؟
بقلم أمين قمورية
«أساس ميديا»
يشتدّ الخناق على بنيامين نتنياهو. المعركة العسكرية في غزة لم تنجح إلّا في تثبيت صورة إسرائيل الدولة القاتلة. المعارك تسير بلا أفق واضح وبلا نهاية. الخلافات تزداد حدّة داخل الائتلاف الحاكم. عضو مجلس الحرب بيني غانتس يهدّد بالاستقالة من الحكومة إذا لم توافق على خطّة للقطاع بحلول 8 حزيران. وزير حربه يوآف غالانت يرفض عودة الحكم العسكري الإسرائيلي إلى القطاع ويطلب تشكيل هيئة حكم بديلة من “حماس” ولم يتلقّ ردّاً من رئيس الحكومة. مسألة اليوم التالي للحرب معلّقة بلا جواب وتفاقم الخلاف بين القيادتين العسكرية والسياسية. قضيّة المحتجزين تزيد من غليان الشارع الإسرائيلي والأنباء عن اعتقال المزيد من الأسرى من الجنود تجعل المشهد العسكري أكثر تعقيداً، وقانون تجنيد اليهود الحريديم يوسّع المشكلات.
إسرائيل إلى الحضيض
في ذروة الانشغال بالمعارك الداخلية، تنهال الضربات المعنوية والدبلوماسية من الخارج. لم تصل مكانة إسرائيل إلى الحضيض كما وصلت إليه اليوم، في مقابل إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ووضعها في إطارها الصحيح. المدّعي العامّ لمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يستلهم تاريخ جدّه محمد ظفرالله خان أوّل وزير خارجية لباكستان وأبرز المدافعين عن القضية الفلسطينية من على منبر الأمم المتحدة. هو أيضاً لم يعبأ للتهديدات الأميركية والبريطانية، ولم يتردّد في تجريم ممارسات قادة إسرائيل. وطلب الملاحقة الدولية لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه بعد اتّهامهما بالضلوع بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية. مثله فعل القاضي اللبناني نوّاف سلام رئيس محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بوقف العدوان على رفح.
أحداث كبيرة لم يكن أحد يتوقّعها قبل شهور، حين كانت إدانة إسرائيل ومحاسبتها مستحيلتين دوليّاً.
الأنكى من ذلك أنّ إسرائيل التي نجحت عبر دعايتها “المقلوبة” في جرّ العالم الغربي خلفها بعد “طوفان الأقصى“. بدأت تفقد رويداً رويداً الدعم المعنوي والسياسي، وراحت تتلقّى الصفعة الدبلوماسية تلو الأخرى لتُحشر في أسوأ زاوية. أحرام جامعات النخبة الأميركية والأوروبية تحوّلت قاعات محاكم صاخبة لإدانة جرائمها وارتكاباتها اللاإنسانية. كاشفة عن عورات المجتمعات الغربية التي كشفت عن زيف ديمقراطيّتها وحمايتها لحرّية التعبير والدفاع عن قيم العدالة والبحث عن الحقيقة.
إسبانيا تغامر من أجل فلسطين..
ثمّ جاء اعتراف ثلاث دول من أوروبا الغربية، هي إسبانيا والنرويج وإيرلندا، بالدولة الفلسطينية وأحقّية قيامها ليشكّل علامة فارقة تعيد لقضيّة فلسطين اعتبارها ومكانتها.
صحيح أنّ هذه الخطوة لا تزال رمزية وأخلاقية إلى حدّ بعيد، وصحيح أيضاً أنّه منذ عام 1988، اعترفت 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. من بينها ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. لكن في الواقع أنّ ستّاً من هذه الدول، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر. جاء اعترافها بفلسطين قبل دخولها الاتحاد الأوروبي، وعندما كانت تدور في الفلك السوفياتي المساند للقضية الفلسطينية آنذاك. لكن أن تقدم اليوم دولة أساسية في الاتّحاد، هي إسبانيا، على خطوة جريئة كهذه، فهذا انقلاب كبير وتحدٍّ استثنائي لدولة غربية لذاتها أوّلاً وللمسار الأوروبي الذي يمشي برمّته مغمض العينين خلف السياسة الأميركية. إسبانيا التي تعاني من مشكلة الحركة الانفصالية في إقليم الباسك. تردّدت دائماً في الاعتراف بدول جديدة مثلما حصل مع استقلال كوسوفو، خشية أن يرتدّ الأمر عليها باعترافات خارجية بالباسك. ومع ذلك قرّرت المغامرة من أجل فلسطين.
في أيّ حال كان للاعتراف الأوروبي الثلاثي تأثيرٌ واسع على الحكومات الأخرى وعلى الأحزاب الأوروبية، إذ أعلن رئيس حزب العمّال البريطاني، كير ستارمر، نيّته الاعتراف بدولة فلسطين المستقلّة إذا فاز برئاسة حزبه مرّة ثانية. ومن الواضح أنّ العدوان على غزة وتغيّر المزاج الشعبي في أوروبا وارتفاع صوت الطلاب والشباب بدأت تلقي بظلالها على سياسات الأحزاب الليبرالية والوسطية المدعومة من أميركا، التي تسعى إلى إبعاد نفسها عن أيّ صلة لها بحرب الإبادة. وإذا حدث تحوّل بريطاني شبيه بالتحوّل الإسباني فإنّ ذلك سيزيد من غضب الولايات المتحدة التي تدّعي حرصها على حلّ الدولتين. فيما تعمل جاهدة على التوصّل إلى حلّ يقزّم الدولة الفلسطينية ويجعلها كياناً ممسوخاً تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
واشنطن تريد دولة منبثقة من مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تجري برعايتها. تكون محكومة سلفاً بواقع ميزان القوى المختلّ لمصلحة إسرائيل، وليس تنفيذاً لقانون دولي أو قرارات أممية. وتالياً فإنّ أيّ اعتراف أوروبي بالدولة الفلسطينية خارج وصاية واشنطن واستناداً إلى القرارات الدولية يهدّد المفهوم الأميركي ويدعم المفهوم الفلسطيني للتحرّر والاستقلال الكامل، كما يؤكّد على اعتبار هذه الدولة: الضفّة الغربية. بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزّة، أراضيَ محتلّة، وهو ما يعني أن لا مشروعية للمستوطنات ولا تشريد للشعب الفلسطيني.
لذا لا يمكن التقليل من أهميّة تحدّي دول أوروبية غربية للمشروع الأميركي الإسرائيلي. هذا من شأنه تكوين رأي عامّ بأنّ القضيّة الفلسطينية بحاجة إلى تسوية وفقاً للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية بإقامة دولتين. كما من شأنه أن يشكّل إجماعاً دولياً يساعد على نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وهو ما يؤدّي في المستقبل إلى إلزام مجلس الأمن بإصدار قرارات متعلّقة بمفاوضات السلام، تلزم إسرائيل بإنهاء الاحتلال للمناطق التي احتلّتها عام 1967 والعمل على الانسحاب منها.
السلطة “مفككة” و حماس “أسيرة”
لكن حتى لا تذهب هذه الجهود مع الريح. لا بدّ من وجود جهة قادرة على استثمارها ودفعها نحو إطلاق مشروع وطني فلسطيني يركّز على ثوابت القضية وعروبتها، وهذا لن يكون إلا بلمّ الشمل الفلسطيني، وإقامة جبهة وطنية فلسطينية موحّدة، لتكون مفاوضاً في عملية جادّة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة.
واقعياً، فإنّ السلطة الفلسطينية الحالية بما أصابها من وهن وضعف واهتزاز ثقة الشارع الفلسطيني بها غير مهيّأة لهذه المهمّة الوطنية الكبرى، وكذلك حركة “حماس” التي على الرغم من صمودها الاستثنائي في غزة والتضحيات الكبيرة التي تبذلها، تبقى أسيرة إرثها “الإخواني” الثقيل، وعلاقتها الخاصة بالمشروع الإقليمي الإيراني الذي بدت مكانتها المميّزة فيه واضحة في مراسم تشييع الرئيس إبراهيم رئيسي في طهران. الأمر الذي ينعكس سلباً على حركتها العربية وتضامن دول عربية أساسية معها وعلى علاقتها مع فصائل فلسطينية أخرى. لذا لا بدّ من جهود فلسطينية من كلّ الأطراف وتقديم التنازلات السلطوية بهدف صياغة مشروع وطني مشترك، فلسطيني القالب عربي الهوى، حتى لا تضيع لحظة تاريخية.
أمين قمورية