وعيُنا لا ينفصل عن تاريخِنا.. وإلا مجرد “كلامولوجيا”!
بقلم الفضل شلق
«اساس ميديا»
عندما ينفصل الوعي عن التاريخ وتبتعد الذات عن إدراك الواقع لدى الجماعات التي أسّست ايديولوجيتها على المظلومية، وبنت كيانها السياسي على فرضية أنها موضع الحرمان والتهميش، وأقصت نفسها عن الاندماج فيمن حولها، ولم يعد لها نصير إلا نفسها، وتعزل نفسها عن محيطها بادعاء التفوق الأخلاقي، وتدعي النصر حقيقةً أو وهماً، فإن أمارة أخرى غير المظلومية تصير جوهر وجودها، ويصير التاريخ عدواً لها، والبشرية مُنكرةً من قبلها.
هي جماعةٌ لا تتقبل الواقع، وتكره من صنعه، حتى ولو كانت هي تصنع أبهر الانتصارات، وبعضها يُحقّق أبهى الهزائم، فهي تنهزم أمام نفسها، وتكابر مقابل إدراكها أن سيطرتها قد انتهت، وأن ما بنت عليه حلمها صار كابوساً. هي لا تسأل كي تعرف ولا تناقش كي تتواصل، بل ينتابها شعور دفين بالذنب إذ أدركت أنها حادت عن مسار التاريخ، ولم تعد ذات انتماء للاجتماع البشري والكوزموس الإنساني.. فهي إما أن تمضي فيما تعتبره غياً كالمقامر الذي أقلقته الخسارة، ولا تستطيع التصالح مع نفسها أو الواقع. ويزداد عداؤها للآخر وتحقد على التاريخ لأنه لا يتوافق مع وعيها، ولا يتطابق مع سرديتها للماضي. بالنسبة إليها تعمّق الشرخ وصار العالم سجناً، وهي أصلاً كانت حياتها مستخدمة لقضية الآخرة. وظنّت أن العالم لا يعنيها بمقدار ما تعنيها الآخرة. هي تخدم الخالق ولكنها جعلته خادماً لها ولأهدافها المباشرة. فهي تعيش من أجل الهدف، وتعتبر الحق الذي لديها هو ما لا حق غيره. وتتصوّر واهمة أن الجماعات الأخرى بانحيازها عن الحق ترتكب ما يجيز التنكيل بها. ترى المشرق العربي خراباً بين جماعتين تقتتلان لا في سبيل إنسانية البشر بل لتحقيق ما اعتبرت الله وعدها به أو وعدت هي الله به. من يُحقّقون ما قادهم إلى قاع الهزيمة أو قمة النصر ينتهون إلى النتيجة نفسها، ولا يُدرك أيٌ منهما أسباب النصر والهزيمة، أو لا يطيق العيش مع من انتصر عليهم أو انتصروا عليه، فيصاب بانفصام الذات، إذ المنتصر لا يشفق على الآخرين، والمهزوم يُكابر فيرفض العيش مع نتائج الهزيمة. ويعتبر التعايش استجداءً، وهو ما لم يتعوّد عليه. يغيب عن بال هؤلاء أن هذه المنطقة كانت على مدى التاريخ مسرحاً للتسوية والعيش معاً. ويغيب عن بالهم أن عمق التاريخ يؤدي الى كثرة وتنوّع، وتزداد الحاجة إلى التسويات، وهذه مهمة السياسة. أصحاب الوعي الذي ينفصل عن التاريخ ويطغى عليه يرفضون التسوية ويعيشون دون تراكم. لا تراكم الغنى بل تراكم التسويات. في ذات كل منا، أبناء هذه المنطقة، أعماق تاريخ لا ينفك عن دراسته علماء التاريخ والأنثروبولوجيا والأركيولوجيا، وتعجز السوسيولوجيا، وهي دائماً أفقية، عن ولوج سوى ما هو على السطح. يُقهقه التاريخ إذ يرى جماعات السوسيولوجيا تنهزم أمامه، فلا يُجيد قادتها إلا “الكلامولوجيا” واجتماعات يومية لقادة يستعرضون عضلات القوة، ويبرمجون لمستقبل يصنعه غيرهم، أي من يُزوّدهم بالمال والسلاح. وأولئك يبالغون بالكلام. وللقوة وجهان متناقضان.
يغيب عن الأنظار أن أساس الكلام لغة من “لغا، يلغو، لغواً”، أو إفصاحاً عما يستحق الكلام. وقد ميّز ابن جني بين الكلام والقول. أما السلاح فهو لغة أخرى عند من لا يملكون غيره للتعامل مع الناس الآخرين. فيتمكن أصحابه من تشييد جدران الفصل من حدود الولايات المتحدة إلى فلسطين، حيث البشرية المعذبة نموذجاً لما تعانيه الإنسانية من انتهاك على مدى الكرة الأرضية. جميعهم ما زالوا يحسبون الأرض مسطحة كما اعتبر القدماء وهياكل الدين، التي لم تُغيّر ايديولوجيتها الباطنة. ويبقى الوعي منفصلاً عن التاريخ، فهو بنظر هؤلاء وأولئك دعوة أو دعاية لا يهمها أن ترى الواقع بمقدار أن تستخرج من ذاتها ما يفيض على التاريخ، ولا يندمج فيه. فيبقى كبقعة زيت على سطح الماء. هو منه ومنفصل عنه في نفس الوقت في نفعية غير براغماتية. والنفعية هي ما يفيدني، والبراغماتية هي ما يفيدني ويفيد الغير، إذ ليست الهوية عندهم في العلاقة مع الآخر الذي بمعنى ما يُحدّد الأنا، بل الهوية المنغلقة التي تُنكر العلاقة مع الغير، فتبقى تدور حول نفسها. فهي لا تعرف سوى النصر أو الهزيمة، ولا يهمها العيش سوية. وتنتهي إلى واحد من إثنين: إما الكبر والاستكبار، وإما التشاوف والإنكار. في الحالتين ليس هناك قضية إنسانية محورها التواصل والاندماج، بل إظهار الأنا والغنى، وكأنها لا بعدها ولا قبلها. يقول المتنبي: أمطِ عنك تشبيهي بما وكأنه/ فما أحد فوقي وما أحد مثلي
في رواية جون ستاينبك بعنوان “أفول القمر”، نرى أن الأنظمة الفاشية، وهي عادة ديكتاتورية، تنكسر ولا تلوي. تنكسر دون إمكانية اللحمة أمام قوى ضدها، ولا تلوي أمام الهزيمة لتعود الى وضعها الأساس عندما يزول ما يضغط عليها.
قال أحدهم، ولا أدري أصل القول إنّ “الدرس الوحيد الذي تعلمناه من التاريخ هو أننا لا نتعلم من التاريخ”. ليس التاريخ حتمياً ولا هو قوة قابعة في مكان ما، تُقرّر مسار الأحداث. لكنه مسار يفرض نفسه بتتابع الأحداث وتلاقي القوى المتناقضة، وافتراقها ومنعطفاتها، الحادة أحياناً، واقترانها وتدمير ما لم يعد لازماً لتطوّر الأحداث؛ ويتكوّن الإنسان من التاريخ وبه ومعه وفيه، والأهم أن يقدر الإنسان أن يفهم التاريخ ويضعه في خدمته لا أن يبقى أسيراً له؛ ولا يستطيع ذلك دون أن يكون أذكى منه. والويل للجماعات التي ذكاؤها دون التاريخ، والتي تعيش وجودها بالنصر أو الهزيمة العسكرية وحدها، دون أن تعتبر التاريخ مجالاً للإنسانية، ولا يقاس إلا بها وبديمومتها. النصر كسر إرادة العدو لا إلغاؤها وهذا هو الفرق بين نتائج الحرب العالمية الأولى والثانية. في الأولى، إلغاء الخصم، وفي الثانية، ديمومته على يد المنتصر. وهذا هو معنى مشروع مارشال. وإذا كان منّا من انتصر فلا لزوم للمساعدة. المنتصر يُساعد ولا يستجدي المساعدة.
يجهل التاريخ من يبني مستقبله على مظلومية ما. فالأكثر عدداً ممن تُصيبهم المظلومية هم الذين يعانون على أيدي أكباش طائفتهم، والطوائف الأكبر عدداً بالتالي تُصيبها المظلومية على يد قادتها بأعداد أكبر من الطوائف الأقل عدداً. وعلى كل حال تتعلّق المظلومية بما مضى، أما المستقبل فيتطلّب بناؤه الارتكاز على المواطنية والتعاون، لا على ما مضى ولا على أحقاد الماضي. تاريخ أعدائنا هو تاريخنا أيضاً والخطأ هو التلاعب أو تكسير تماثيلهم ومقاماتهم، وهذا لا يقل فداحة عن الظهور بمظهر من يدافع عنها في حروب أهلية تُناقض مبدأ العيش سوية. من انتصر علينا في الماضي هو جزءٌ من تاريخنا شئنا أم أبينا. يحدث شرخٌ بين الوعي والتاريخ عندما نتلاعب بالنصوص حول الماضي أو ما شيّد فيه من أبنية ومقامات وتماثيل وتذكارات مادية. ليس الماضي ملكاً لنا، والأسوأ تفتيت الماضي، فيصير بعضه ملكاً لبعضنا دون الآخرين، ويصير التنافس بيننا حول الماضي بدل أن نعمل سوية لبناء المستقبل الذي يفلت من أيدينا لأسباب من هذا النوع. يصير المستقبل ملكاً لنا حين نصنعه، وعندما يخرج وعينا من الماضي إلى التاريخ الذي يحوي المستقبل بين أحشائه. عندما نعيش في الماضي ننهزم أمامه، وهذا يقودنا الى هزيمة أو هزائم في الحاضر. علينا أن نتعلّم من الماضي لا أن نعيش فيه؛ الماضي أشبه بالقبر الذي لا يصلح للحياة التي ينبغي أن تتمتّع بانفساح الحاضر والمستقبل. تدفن إسرائيل نفسها في صهيونية الماضي وهذا ما سوف يُحقّق أجلها، وأن نمارس الأمر نفسه يصيبنا نفس المصير. إسرائيل نقيضنا ولا لزوم أن نجعل أنفسنا الوجه الآخر في المرآة. تستنجد إسرائيل بقوى الغرب الذي صنعها وسيكون مستقبلها متعلقاً به. وللتاريخ منعرجات يصعب التنبؤ بها كما يصعب التنبؤ بالزلازل والعواصف والحرائق. ومن يدّعي أنه يُسيّطر على المستقبل هو كالقابض على الماء. *** مستقبلنا نصنعه نحن بالتعاون والنهوض والحداثة والخروج من الماضي، وإنتاج ما نحتاجه، والانتقال من النمط الاستهلاكي إلى نمط إنتاجي؛ وعندما نُقاتل بأسلحة يُزوّدنا بها الغير فإننا نمارس نمطاً استهلاكياً، يجعلنا عرضة لأهواء من يصنع.. وتتفاقم الهوة بين الوعي واالتاريخ. أن نصنع وننتج يتطلّب جهداً وعملاً دؤوباً وصبراً، فالتاريخ في صالحنا والمستقبل قيد إرادتنا. والاتكال على الغير بالسلاح مؤداه الاتكال على الغير بالايديولوجيا، فيستحيل الوعي الذاتي ويستحيل صنع التاريخ بما فيه المستقبل، وما يجب مقاومته هو الاتكال على الغير والاكتفاء بنمط استهلاكي في الفكر والممارسة. وعندما تتسع الهوة بين الوعي والتاريخ، نزداد بُعداً عن الواقع وينتهي بنا الأمر إلى انكاره، فنحاول تغطية الأمر بـ”الكلامولوجيا”. هكذا ظنّت المقاومات الماضية عندنا، منذ أحمد الشقيري مروراً بالمقاومات المختلفة وجبهات الرفض واليسار المغامر، أن في النقد الموجه إليهم استكانة واستسلاماً. ولم ينظروا إلى أنفسهم وعجزوا عن رؤية مواضع الخلل، بل ازدادوا قصوراً. كأن ما في نواياهم يُغني عن الواقعية. وكأن في استعجالهم ما يُغني عن الرؤية. فغابت عنهم تعقيدات الواقع وتعرجات التاريخ، واقتصر الوعي على الرغبات التي جنحت إلى اللغو الكلامي أو ما يسمى “الكلامولوجيا”. قال الشاعر تعليقا على القمة العربية في الرباط: خافوا على العار أن يُمحى/ فكان لهم على الرباط لدعم العار مؤتمرٌ ما دام العار مُعشعشاً في حنايا عقولنا باتساع الهوة بين الوعي والتاريخ، وبين الرؤية والواقع، وبين الفكر والحقيقة، فإننا سوف نجد أمامنا عقبات تعيق نهوضنا.
الفضل شلق

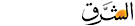
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.