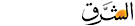الرياض: حدثان اثنان لحلّ لبنانيّ جذريّ
بقلم جان عزيز
«اساس ميديا»
في الأيّام القليلة الماضية، كانت مدينة الرياض مسرحاً لبحث جدّي وعميق وجذري لحلّ أزمات لبنان الأكثر جوهرية، من دون علمه، ولا علم الباحثين.
قسمٌ منه خرج إلى الإعلام. قسمٌ آخر ظلّ مستتراً، على الرغم من أنّ إعلاماً آخر استعرضه، ولم يكشف أبعاده.
في المحصّلة، لا شيء نهائياً طبعاً. لكنّه مسار غير مسبوق، للمرّة الأولى منذ أكثر من 75 سنة، لحلّ لبنانيّ جذريّ شامل.
صحيح أنّ أزمات هذا الكيان النهائي تبدو مثله نهائية. متشعّبة هي ومتراكبة، في فردِه وجماعاته ونظام دولته وعلاقته بمحيطه والعالم.
لكنّ الأكيد أيضاً، بل المسلّم به بالإجماع، أنّ حدثين تاريخيَّين اثنين فاقما عوارض “المسألة اللبنانية” المستدامة.
أوّلهما قيام إسرائيل، قبل عام 1948 وبعده. كان صدمة أحدثت خللاً في مكوّنات الدولة اللبنانية الحديثة كليّاً، وخربطت معادلاتها كافّة.
يطول الحديث والشرح المعروفان عن ذلك. لذا ربّما يكفي تعداد عناوين التداعيات:
– اللاجئون وأزمتهم المتعدّدة التعقيدات.
– اهتزاز شيء ما في الميثاق الطريّ العود حتى الهشاشة، نتيجة الارتباط الحقيقي للوجدان العربي والمسلم بقضية فلسطين.
– قيام نموذج كيانٍ تمييزيّ محاذٍ لكيان تعدّدي.
– استثارة أوهام عتيقة لدى البعض، بدليل ما وثّقه الكتاب المرجع، “المتاهة اللبنانية”، للمؤلّف الإسرائيلي رؤوفين إرليخ.
أقلّيّات مذعورة الهويّات
أطماع الكيان الجديد الشاملة في لبنان، أرضاً ومياهاً ودوراً، وبالتالي بدء التنافس، ولو فكرةً مكتومة يومها، في قطاعات الاقتصاد كافّة، من مرفأ بيروت إلى مصرفها وجامعتها ومستشفاها وخطوط تجارتها ونفطها، التي، للمفارقة، دمّرناها كلّها في زمن السيادة والتحرير.
يضاف إلى تلك العناوين الداخلية أخرى خارجية، مثل استثمار الأنظمة العربية لهذا الوضع لتبرير سلطويّاتها على شعوبها، ووقوع القضية الفلسطينية لاحقاً ضمن صراع نظام القطبين، ثمّ ضمن تشوّهات النظام الأميركي الأحاديّ، بعد سقوط موسكو الحمراء، وصولاً طبعاً إلى تأثيرها حتى على بعض أنماط السلوك الاجتماعية المعتورة، بدءاً بحاجة مجتمعات المنطقة كلّها إلى من ترمي عليه مسؤوليّة فشلها في بناء دول حديثة مزدهرة تحترم حقوق الإنسان الخاصّة والعامّة، وما أفضل من الكيان الغاصب لتحميله بؤس هذا الشرق كلّه، من أنظمة “القائد الخالد”، إلى أزمة الغذاء والسلطة في موريتانيا، وانتهاء بأقليّات مذعورة الهويّات، حيال هاجس إلغاء الأكثرية لها وواقعه، فانشطرت بين انتحاريّين أو مستقيلين أو مهاجرين، وبين متكيّفين وجدوا في المزايدة في قضية فلسطين أفضلَ قناعٍ لسترِ ذمّية سياسية مفهومة.
وبالفعل لم تمضِ أعوام قليلة على قيام إسرائيل حتى تفاقمت أزمات لبنان وتفجّرت ولمّا تزَل.
الثّورة الخمينيّة وتداعياتها
ثاني الحدثين التاريخيين كان الثورة الخمينية في إيران في شباط 1979، خصوصاً في تأثيرها على الداخل اللبناني، كما على نظام العقل العربي.
في لبنان يكفي عنوان الحزب. إذ هو جسمٌ أكبر من الدولة والوطن، غيّر فيهما، حتى ما عادا معروفين وطناً ودولة لبنانيَّين. وذلك عبر تغيير عميق في الطائفة الشيعية. جَبَّ كلّ ما كان قبله، فطوى في ما طوى قروناً من فكر شيعي لبناني، من السيّد عبدالحسين شرف الدين إلى السيد محمد حسين فضل الله، ومن السيد محمد جواد مغنية إلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين وما بينهم من عشرات الأعلام والأسماء. وهو ما انعكس على كلّ ما هو لبنان، سيادةً وسياسة، اقتصاداً وسوسيولوجيا وعمراناً وعمارة وتربية وثقافة وعلاقات خارجية.
لكن كان هناك أيضاً تأثير ثورة الخميني على لبنان، عربياً. ذلك أنّها جاءت في لحظة تقاطعات تاريخية غريبة مستغربة، أو هي كانت فعلاً على علاقة سببية، بين خلفيّات وتداعيات، مع سلسلة طويلة من التطوّرات المتزامنة:
اشتداد الحصار الأميركي على الاتحاد السوفيتي، خصوصاً بعد وصول ريغان إلى البيت الأبيض سنة 1980، واللجوء ضمن أسلحة هذه الحرب وأدواتها إلى تزكية الهويّات الدينية، غرباً عبر تنبّه واشنطن لبزوغ ظاهرة البابا البولوني يوحنّا بولس الثاني، وبدء حفرها في مرفأ غدانسك البولوني، لزعزعة جدار برلين، وشرقاً مع الدعم الأميركي السرّي أو حتى العلني لحركات الصحوة الإسلامية المختلفة بغرض التأثير على الجمهوريات الإسلامية الحمراء. وهو ما يفسّر جزئياً أحداث أفغانستان المتزامنة، ثمّ الاجتياح السوفيتي لها نهاية 1979، وانطلاق حركات “المجاهدين الأفغان” و”الأفغان العرب”، مع ما كان لذلك من تأثير على المنطقة العربية كلّها، وخصوصاً على المملكة العربية السعودية، وبالأخصّ مع حادثة جهيمان والحرم المكّي، المتزامنة أيضاً وأيضاً، في تشرين الثاني 1979.
إزاء هذا المناخ العامّ، دخلت المنطقة برمّتها في حالة من “العودات الدينية” إلى قلاع المذاهب الذاتيّة وحصونها الأكثر تشدّداً. وبدا وكأنّ في العالم العربي السنّيّ من اضطُرّ إلى التفكير والسلوك وفق قاعدة أن لا سبيل لمواجهة الراديكالية الشيعية الخمينية إلا براديكالية سنّيّة مقابلة.
وكان لبنان عرضة لذلك كلّه، من توتّرات داخلية وضغوط خارجية، وصولاً إلى قصور في الوعي والاستيعاب لدى غالبية نخب الجماعات اللبنانية، حتى كان ما كان.
في الأيام القليلة الماضية، وفي مدينة عربية واحدة، هي الرياض، كان حدثان اثنان. لا علاقة لأحدهما بالآخر، لا مضموناً ولا شكلاً ولا بأيّ تفصيل. لكنّهما في أبعادهما يطرحان حلولاً جذرية لأزمة لبنان.
– أوّلاً القمّة العربية الإسلامية في الرياض، التي أكّد فيها ولي العهد أنّ “فلسطين أمانتنا”، والتي ثبّتت بصورة نهائية التزام هذه المجموعة بقيام دولة فلسطين، على قاعدة حلّ الدولتين، مع ما يعنيه ذلك مكاناً ومكانةً، وهو ما يرسم مساراً لا عودة عنه لهذا الحلّ.
– ثانياً، عرض المبدع اللبناني إيلي صعب، في الرياض أيضاً، بما ومن جمع وتضمّن، وعلى جزئيّته واختلافه النوعي عن السياسة الدولية وبشاعاتها، حدثٌ جماليّ يشي بقرار رسمي كبير بتأكيد وتثبيت مسار المنطقة صوب الحداثة على قاعدة الانقلاب على خيار مواجهة الخمينية بمثلها، أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات، والذهاب إلى الخيار المعاكس تماماً، بمواجهة التطرّف بالانفتاح، ومكافحة الرجعية بالتطوّر، وفق معادلة أنّ الازدهار شرطُه الاستقرار. والاثنان لا ينموان إلّا في تربة الحرّيات والحداثة والعصرنة.
من كان يفكّر؟! من كان يأمل أو يحلم؟ حلُّ معضلتين أنهكتا لبنان: الصراع لقيام فلسطين، والصراع الديني المذهبي بتداعياته القاتلة كافّة. مسارٌ طويل طبعاً، وغيرُ مضمون حتماً، لكنّه مسار بدأ، وباتت له وجهة أكيدة.
جان عزيز