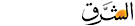سيرتي كنازحة: حين اكتشفتُ أنّني أنا “الآخر”
رنا نجار
«أساس ميديا»
هنا سيرة سريعة ليوميّات واحدة من أفراد أسرة “أساس”، وهي تبحث عن مسكنٍ لها، بعد النزوح والتهجير، وعن مساكن لعائلتها التي تناتشتها مناطق لبنان الكثيرة والمتفرّقة، من بعلبك إلى عاليه والشوف وإهدن وبيروت وجبيل وكسروان والمتن وتنّورين وطرابلس.. وصولاً إلى صيدا.
“من طلع من دارو قلّ مقداره”، قالت لي قريبتي التي نزحت من قريتنا شمسطار (غرب بعلبك) مع أولادها الخمسة بعد اشتداد القصف أواخر أيلول الماضي، والغصّة في صوتها.
تفرّقت عائلتنا بين عاليه والشوف وإهدن وبيروت وجبيل وكسروان والمتن وتنّورين وطرابلس وصولاً إلى صيدا. اضطررنا جميعاً إلى تغيير أماكننا من الأخطر إلى الأقلّ خطراً، مرّات عدّة. لكلّ منّا معارفه، فينزح إلى حيث يتوافر له مسكن، أو إلى مكان متاح لطبقته الاجتماعية، ثمّ أصبحت المعايير تعتمد على تقبّل المكان للنازحين من الطائفة الشيعية، سواء كنّا ننتمي إليها “سياسياً” والتزاماً دينياً، أم كانت دمغة على الهويّة.
كلّنا مشتّتون على مختلف انتماءاتنا… ننام ونأكل ونشرب في أمكنة مؤقّتة. نفتقر إلى البيت، المنزل، السكن الذي نسكن إليه ونطمئنّ ونحتمي به. كلّ بيوتنا الشتوية والصيفية باتت تحت رحمة تهديدات أفيخاي أدرعي وخرائطه.
هي وهي
التواصل مع العائلة قليل. لكنّ قريبتي مصابة بالسرطان، وتتابع علاجاً صعباً وتعاني آلاماً فظيعة في العظام. لذا أتواصل معها بوتيرة مكثّفة. لا نشبه أنا وهي بعضنا بشيء. نحن فقط نحمل اسم عائلة واحدة وفئة الدم نفسها، وتجمعنا ذكريات الطفولة. أنا أنتمي إلى عائلة أكثر تحرّراً اجتماعياً، ومنبوذة بعض الشيء من محيطي العائلي والمُباشر، ويقولها لي البعض: “منحسّ إنك مش منّنا”. أمّا هي فراضية مرضيّة. بَصَمَت بالعشرة وغرقت في طاعة النظام الأبوي والديني كما أراد والداها. محجّبة وملتزمة دينياً،.وفي عائلتها الصلاة. واجبة وإجبارية، كما الحجاب الإجباري في المدرسة الدينية التي أُدخِلت إليها.
“حشرة” الذّلّ
تكره “سيرو” الخرائط وليس لديها حسّ الاتّجاهات. لا تعرف المرج من المريجات، ولا تنّورين من بشرّي. الحرب هجّرتها من البقاع، وجعلت منها “ابن بطّوطة” محلّياً أو “سلحفاة أحمل بيتي على ظهري”، كما تقول ساخرة. فكلّ أسبوع تنتقل إلى مكان جديد، ممشّطة المناطق الآمنة. تحاول قريبتي أن تمكث في بيوت معارف أبيها المتقاعد في الجيش اللبناني. وبالتالي معارفه من مناطق وطوائف وملل مختلفة. أمّا هي التي لم تبنِ أيّ شبكة علاقات ملوّنة، فلا تعرف أيّ مكان آمن!
حاولت السكن في بيوت معارف أبيها، مع عائلات أخرى، لكنّها لم ترتح: “كلّ بيت كنت حسّو سجن، كنت حسّ رح اختنق مش قادرة إشلح عن راسي ولا إتفرّع، وكل ما حدا حكي أيّ كلمة عن ضيق المكان أو الضجّة حسّ إنو عم يلطشني… إبكي واحمل ولادي وفلّ”. ثمّ تبدأ البحث عن مكان جديد وأمان مفترض أو وهمي.
ليست المشكلة بالمكان، إنّما بهذا التشوّش والتنقّل المقيت الذي يُشعر صاحبه أنّه متروك، فلا دولة تسأل عنه ولا حزب ولا طائفة ولا حتى أقارب.
عندما كنّا صغاراً كنّا نجتمع سبع عائلات في بيت جدّي أيام العطل. تربح حميمية الاجتماع والنوم “كعب وراس” تحت الناموسية، على الخصوصية. سهرات رقص وغناء حتى الصباح في أقلّ من 100 متر مربّع. “الحشر” هنا حاجةٌ ومطلب واحتفال ننتظره من مناسبة إلى مناسبة، وقرار شخصي. لكنّ “حَشرة” قريبتي مع أهلها وأطفالها وغرباء، هي مأساة، ذلّ، انكشاف، واختراق لكلّ خصوصية.
“أشعر أنّنا عراة والجميع ينظر إلينا، إمّا شفقة وإمّا تشفّياً أو شماتة”، تقول. وتسأل: “ما ذنبنا نحن أن نتبهدل بهذه الطريقة ونسكن في بيوت تغزوها الرطوبة أو نفرض نفسنا على عائلات لا نعرفها فتضاف إلى غربتنا وحشة التواصل والمعاشرة والذلّ، بعدما كنّا نعيش في بيت 400 متر مربّع تحوطه الحدائق والبساتين”.
لا أردّ عليها لأنّها تعرف رأيي وتعرف معارضتي للحرب منذ اللحظة الأولى وتعرف جيّداً معارضتي للحزب الذي تناصره منذ ترك جبهة الجنوب وقرّر توجيه سلاحه إلى اللبنانيين في 7 أيار 2008، ويوم شارك في قتل أصدقائي الثوّار في سوريا ودافع عن مصالح الدكتاتور من أجل عيون المرشد الأعلى!
يئست من وهم البحث عن أمان، فقرّرت العودة إلى الضيعة: “تحت القصف إيه، بس تحت سقف بيتي، بموت مرتاحة أحسن ما موت مشرّدة”!!!
حبّينا نتعرّف
ليس المقال عن السياسة، لكنّ صدى صوت قريبتي العاتِب، ودموع أمّي التي تعبت من التنقّل بعدما أصبح بيتها شبه مدمّر في الغارات التي شنّت على شارع الجاموس في الحدث… كلّها دوّت دفعة واحدة في رأسي، عندما انتقلت نازحة من الجيّة إلى فرن الشباك ثمّ إهدن ثمّ بيروت، وبعدئذ إلى مار مخايل في بيروت.
عندما تسلّمت مفتاح الشقّة، بعد حوالى 20 يوماً من البحث المضني عن مكان لائق مفروش، بسعر منطقي، يؤوينا أنا وأمّي وابنتي، طرقت الجارة السبعينية الجرس، قبل أن يتسنّى لي وضع المفتاح على الطاولة. “بونجور مدام”. لم أكد أنتهي من البونجور مع ابتسامة عريضة، حتى عُقد حاجباها تأهّباً وانهالت عليّ بالأسئلة دفعة واحدة: عملي؟ اسمي؟ مكان سكني السابق؟… “ما تواخذيني بس حبّيت اتعرّف عليكِ. قالولي جيتي اليوم. بتعرفي الوضع بخوّف ونحنا ما منأمّن. في ناس عم تستأجر بأسماء مستعارة على Airbnb”. فهمت المقصود.
رددت عليها بالفرنسية:
“Ne t’en fais pas madame je suis journaliste et pas terroriste”. ثمّ دعوتها إلى الدخول. دخلت مجدّدة الأسئلة، فعائلتي نجّار محيّرة وأتحدّث الفرنسية وقلت لها إنّني أعمل مع مؤسّسات صحافية أجنبية وعربية كبرى. لستُ محجّبة. وأحمل مع أمتعتي شنطة فيها مشروبات روحية أو أدوات تخفيف التوتّر عندما يشتدّ القصف ليلاً على الضاحية… حدّقت الجارة بالشنطة الشفّافة، وبات كلّ بؤبؤ في إحدى عينيها ينظر إلى الآخر بقلق.
تحقيق أمنيّ مستمرّ
دخلتُ الموضوع مباشرة وبلهجة حاسمة: “أنا شيعية ولست مناصرة للحزب، وأكره إسرائيل”. قلتها بلكنة شعبولا المصرية! “آه إنت أكيد شيوعية؟”. أردّ: “كمان لا… لا أؤيّد الحزب ولا أيّ حزب آخر، وليست لي أيّ علاقة به من بعيد ولا من قريب، ولا أحد من أفراد عائلتي الصغيرة والكبيرة يعمل في صفوفه”.
شهقت ووضعت يدها على فمها المفتوح على آخره. أحرجتُها، فأجابت: “أعتذر لكن حقّي أن أخاف. ألا ترين ما حصل في أيطو بزغرتا. الوضع ما بطمّن”. حاولت تكحيلها فعمتها. “أردت أن أطمئنّ عليك فقط، فالإيجارات غالية هذه الأيام وأنت صحافية، فهل تستطيعين دفع الإيجار أم لديك من يساعدك؟”.
لبست وجه “angry bird” وتحلّيت بـ “لغة الظرافة” التي تعلّمتها في دورات حلّ النزاعات مع المطران غريغوار حداد، للتواصل مع الآخر!
عادت جملة قريبتي إلى رأسي: “من طلع من داره قلّ مقداره”! لكنّ المرأة تفتح معي تحقيقاً رسمياً كالذي تفتحه السفارات الأجنبية مع من يتقدّمون بطلب “لمّ شمل” أو لجوء إلى بلاد توفّر لهم رغد العيش بكرامة وطمأنينة ورخاء.
ذكّرتني السيّدة بموظّفة في إحدى السفارات الأوروبية كدت أنفجر أمامها تماماً وأنا أنتظر تقديم طلب تأشيرة سياحة، لكثرة ما سألت صبيّة تريد الالتحاق بزوجها عن خصوصيّاتها: “كم مرّة تنظّفين أسنانك، وزوجك؟ هل تصلّين؟ كم مرّة؟ كم رقم حذاء زوجك؟ كيف تعرّفتِ على زوجك؟ متى كانت أوّل قبلة؟ متى تحجّبتِ؟…”.
هذا النوع من التحقيقات كانت تجريه مخابرات الحزب أيضاً، بسذاجة الجارة تماماً. في الحرب تقدّم أبي اليساريّ بطلب ليعلّم الفرنسية في مدارس المصطفى التي كانت تدفع مقابلاً مادياً جيّداً نظراً لراتبه المتواضع في التعليم الرسمي. أرسل الحزب عناصره للتحرّي عن أبي في الحيّ. أخبرونا الجيران أنّهم سألوا إن كان يُصلّي؟ إن كان يشرب الخمرة؟ إن كان يحبّ الحزب؟ ثمّ أرسلوا أستاذاً ذا لحية خفيفة ومعلّمة تلبس شادوراً، لزيارتنا في البيت، بحجّة أنّهم يريدون الاطمئنان على أبي واستكمال الطلب. وسألا عن الصلاة تحديداً، وبحثا بمكتبة أبي الضخمة… انتهت الزيارة.
يومها خافت أمي كثيراً، خصوصاً أنّ رفاقاً كثراً من منظمة العمل والحزب الشيوعيَّين اغتيلوا في الفترة نفسها. كان أبي متفائلاً بمقاومة ذات دم جديد وهو المصلح الاجتماعي الشاكر النعم بطبيعته، الذي يحبّ التأقلم مع المتغيّرات الاجتماعية والسياسية ويحاولة فهم وجهة نظر الآخر مع حبّة نقد… لكنّه لم يعرف أنّه هو “الآخر” أو بالمعنى الشعبي “المنبوذ” الذي لم يستطع التأقلم مع “لغة التجسّس والنظام الشمولي الذي تحرّر منه بخروجه من المنظّمة”.
كنت أعتقد أنّني “الآخر” في ضيعتي الشيعية وفي الحيّ الذي سكنه أهلي في ضاحية بيروت الجنوبية، وفي الفرع الأول لكلّية الإعلام، وبين مناصري الحزب وحركة أمل، الآخر لأنّ أبي كان يسارياً ناضل ضدّ الوجود السوري المخابراتي في لبنان، الآخر لأنّني حرّة وأناصر كلّ القضايا المحقّة من احتلال فلسطين إلى إسقاط الأنظمة الدكتاتورية والتمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنسية…. أنا الآخر لأنّني رفضت الاندماج في النظام الطائفي واعتبرت الحجاب تكبيلاً وسجناً لجسدي. أنا الآخر الذي طُرد أخيراً من مركز للإيواء لأنّني غير منتمية إلى “بيئته” ورفضت الإجابة عن سؤال أحد عناصر الحزب الذي منعني من التصوير: “هل تحبّين السيد؟”. لكن هنا، صرت أنا “الأولى”، وبات “الآخر” يراني “مِتوالية”، أيّاً كانت ميولي وآرائي ومواقفي السياسية.
فحص دم “شيعيّ”
لم تفحص الجارة دمي إن كان خالياً من الكحول؟ لم تسأل إن كنت آكل لحم الخنزير المشوي والمقدّد المبهّر الذي فوجئ زميلي العونيّ المنفتح بأنّني أتناوله: “بتاكلي خنزير، أكيد إنت شيعية؟”. لم تسأل إن كنت أتحدّث الفارسية بطلاقة؟ كما سألني صديق فرنسي من أشهر الأطبّاء، عندما عرف أنّني شيعية من لبنان، معتقداً أنّ كلّ شيعي ينتمي إلى ولاية الفقيه!
الجارة التي تحاول أن تكون لطيفة، إنّما تفضحها أسئلتها وتُظهر إصابتها برهاب الشيعة بعد تفجير أيطو: “أنت من الضاحية أم من الجنوب؟”، سألتني. قلت في نفسي “اللهمّ طوّلك يا روح”، وصرت أوشوش نفسي كالمجانين.
يبدو أنّ الجارة لم تسمع بأنّ في البقاع وبعلبك والجبل وحتى الشمال شيعة. ولم تعرف أنّ في الجنوب والضاحية وغيرهما من المناطق المستهدفة بسلاح الطيران الإسرائيلي لبنانيين من كلّ الطوائف…. ولم تسمع بـ”شيعة السفارات”، اللقب الذي أطلقه أنصار الحزب على كلّ من والى عليّاً ولم يوالِ ولاية الفقيه والملالي، وكلّ من عارض الفكر الشمولي. هذه السيّدة الستّينية التي توقّفت عند ستيريوتايب (stereotype) وقاموس الحرب الأهليّة: مِتوالي = جنوب = ضاحية.
صلّبت يديّ على وجهي كما كان يفعل أبي عندما يفور غضبه، وقلت لها: “أنا من هناك. من بلد الماحدا المش راكب ولا رح يركب…”. ضاعت مرّة أخرى.
رنا نجار